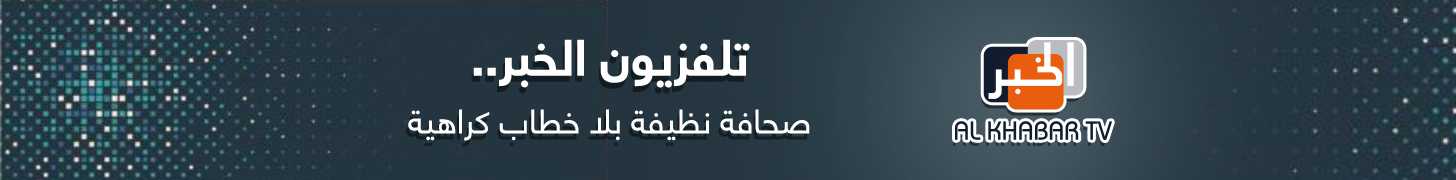عن الحرب والمثوى الأخير : مدنٌ تضيق بموتاها وأرياف تفتح ذراعيها لأحبابها كأبٍ حزين

كما غيّرت الحرب حقول القمح، و منازل المدنيين، وشوراع وأزقة المدن الساخنة في سوريا، عرّجت أيضاً على المقابر، ورفعت أسعارها في تلك المدن الجميلة، حيث تبقى العيون ساهرة على ذكرى موتاها.
في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، يبقى سعر القبر أثقل وأقوى وأشد وطأة على القلوب الحزينة، ورغم اختلاف أسعار المراقد بينها، إلا أنها اتفقت جميعها على أن تكون مرتفعة، في حين يهدأ الريف الوديع، ويستقبل ترابه أجساد أبنائه بدفء ودون نقود.
ومن نتائج الحرب المستمرة في عامها السابع أن ارتفع عدد الوفيات بشكل غير مسبوق لأسباب لم تعد خافية على أحد، ارتفاعٌ زادت معه الحاجة إلى مراقد لجثامين المتوفين، ما دفع أسعار “سوق الموت” ومستلزماته إلى القفز بشكل مضاعف في المدن خاصةً ، فارتفعت أسعار القبور فيها بشكل جنوني أحياناً، بينما بقيت هذه القبور مجاناً لأبنائها في الريف.
وتبدو جنازة الشهيد حاضرة في أذهان معظم السوريين، حيث تخرج القرية حاملةً الصور والأعلام إلى رقعة صغيرة من أرضها لتحتضن جسد الشهيد دون التفكير بسعر قبر أو كلفة.
وفي المدن تختلف الأحوال، وترتفع الأسعار، حتى ليبلغ سعر القبر في مدافن دمشق أكثر من مليون ونصف مليون ليرة، بينما يصل في مدينة اللاذقية إلى نحو100 ألف ليرة، و في حلب 23 ألف ليرة لينخفض في حمص إلى عشرة آلاف ليرة.
في دمشق، ضاقت 33 مقبرة داخل العاصمة السورية، بـ الوافدين الجدد إليها، وفشلت في استيعاب المزيد، ما اضطر “مكتب دفن الموتى” إلى تخصيص أرض كبيرة في منطقة الحسينية جنوب دمشق، وإنشاء مقبرة جديدة، وفي هذا ما يعزز المثل الشامي القائل “فوق الموتة عصة قبر”.
ووصلت المعاناة الناجمة عن ضيق المقابر بسكانها من أهالي دمشق إلى أن لجأ الكثير من أهالي دمشق لشراء قبر لكل أسرة في مقابر دمشق المعروفة ( باب الصغير – الدحداح وغيرهما) ليواروا جثامين أحبائهم فيها ، فيستضيف القبر الواحد جثمان الأب والأخ والأم ، ولكن على أن يفصل بين وفاة كل منهم خمس سنوات على الأقل .
ويبدو أن الحرب ألغت هذا الشرط الشرعي لتعمد العديد من الأسر إلى دفن موتاها دون التقيد بالمدة الزمنية المحددة في أوقات السلم.
ورغم ذلك، حصلت خلال سنوات الحرب الكثير من الأحداث الغريبة فيما يتعلق بمقابر دمشق، إذ اكتشف كثيرون من أهل الشام أن قبورهم التي تضم أجساد أفراد عائلاتهم تم بيعها من قبل “سماسرة الموت” لآخرين دون علمهم وبمبالغ خيالية أحياناً، واستغل السماسرة هجرة بعض العائلات إلى خارج البلاد للقيام بفعلتهم.
و قبل نشوب الحرب في سوريا، كانت محافظة حلب تتميز بجمال حدائقها واتساعها، وتوزعها في كل الاتجاهات التي تشكل متنفساً للأهالي، ولكن مع اشتعال الحرب خيم شبح الموت على الشهباء ليحصد أرواح الأهالي المدنيين، فتحوّلت هذه الحدائق مع مرور الوقت إلى مقابر.
ومع استمرار سقوط القذائف على الأحياء السكنية، من قبل المجموعات المسلحة التي كانت تتمركز في الأحياء الشرقية، تحوّلت أكثر من 20 حديقة في أحياء حلب الغربية إلى مقابر، إذ لم يجد الناس المحاصرين في أحيائهم مكاناً لدفن مواتهم سوى الحدائق القريبة منها.
وكانت محافظة حلب أوقفت الدفن في العام 2013 وعادت إليه في العام 2016 ، واتُخِذَ هذا القرار بعد أن تحوّلت المنطقة إلى خط تماس نشط، على طرفيها نقاط سيطرة للجيش العربي السوري و “الوحدات الكردية” وعلى مقربة منها نقاط سيطرة ل “المجموعات المسلحة” المختلفة.
ومع تنامي الحاجة إلى المزيد من القبور في اللاذقية، زاد أسعارها بشكل مبالغ به، بعد ارتفاع عدد السكان في منطقة ما على حساب أُخرى، جراء حركة النزوح الداخلية، الأمر الذي جعل السوريين يستسهلون دفن ذويهم في القرى البعيدة.
في خضم هذا الواقع القاسي لمدافن المدن، باتت الأرياف وحدها القادرة على استيعاب المنتقلين إلى رحمته تعالى، بدلاً من رحمة تجار الحرب أو ظلمهم، بما فيهم تجار الموت في الزمن السوري الصعب.
وتتجاوز معاناة السوريين التكاليف الباهظة لأسعار القبور ومتطلبات الوفاة، إلى حد استحالة تنفيذ وصايا ذويهم بدفنهم حيث يرغبون، بينما بقي الريف كأبٍ حزين يفتح ذراعيه باكياً ليستقبل جثامين أبنائه.
سها كامل – تلفزيون الخبر