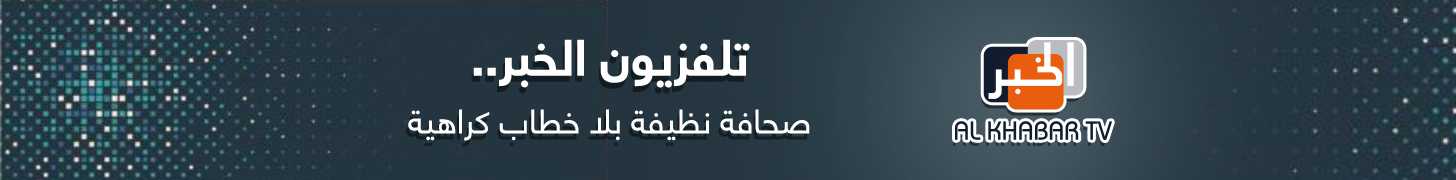طريق المدرسة معبد بالحنين.. ذكريات يسترجعها أصحاب المكان

يعتبر معظم طلاب المدارس سنوات دراستهم بها ككابوس طويل يحتاج 12 سنة حتى ينتهي، وما أن تنتهي “سنوات العذاب” حتى يعود دفق الذكريات محملاً بحنين لكل حدث صغير وبسيط، ولعل أجملها تفاصيل طريق الرحلة الممتد من باب المنزل حتى باب المدرسة، أصدقاء صف وجيران سفر تقاسموا الضحك والمطر على طول الطريق.
تحدثت ميساء لتلفزيون الخبر عن طريق مدرستها في عام 1979، مدرسة الشهيد حسن طراف، في بانياس، “مدرستي كانت بعيدة عن المنزل، وللوصول إلى المدرسة كان علينا الاختيار بين طريق السوق أو الطريق الزراعي، الذي كنا نسلكه عندما يكون الطقس ملائماً، ونأكل مما زرعه أصحاب الأرض من بندورة وليمون وخيار وما إلى هناك”.
وأضافت ميساء: “كنا نمر من طريق السوق عند العودة من المدرسة، أو في الأيام الماطرة هرباً من الطين، لمشاهدة المحال التجارية و”عجقة العالم”، من أمهات يتسوقن وموظفين يشترون المواد الغذائية لأسرهم، وباعة على بسطات بسيطة وعليها خضار أحضروها من القرية ليسترزقوا منها”.
تروي ميساء ذكرياتها وعيناها تلمعان ضاحكتان وآلاف القصص في مخيلتها، لتضيف أن الأرض الزراعية في بانياس تحولت إلى أوتوستراد تمتد على جانبيه الأبنية العالية، واندثرت معالمه تماماً، حيث لم يبق منه إلا ذكريات يسترجعها من زرعها وأكل من خيراتها أو من اتخذها طريقاً للوصول إلى وجهته، كما تحولت مدرسة الشهيد حسن طراف من مدرسة ثانوية إلى مدرسة فنون نسوية.
وفي بانياس أيضاً، تشرح لينا عن طريق مدرستها الابتدائية، مدرسة الراهبات سنة 1970، التي كانت بناء ملحق بالدير، مستذكرةً عدد المرات التي وقعت بها على الدرج الحجري الذي كان طريقها للوصول إلى طريق المدرسة، إضافة للوقت الطويل الذي كنت أشعر به حتى انهي نزل ذلك الدرج “.
وأكملت لينا: “أكثر ما أشتاق له هو العم أبو محمد، بائع الحلوى، كان يحمل صحن قش كبير على رأسه، وعليه أكياس “المعلل” زهري وأبيض، وكان سعر الكيس 50 قرش (نصف ليرة)، ولم تزل في البال كيف كنت أشتري يومياً “سمونة وكولا” بليرة واحدة فقط”.
وتحولت مدرسة الراهبات في بانياس إلى مدرسة التجارة لطلاب الثانوية، والآن هي روضة أطفال، وبقيت موجودة ببنائها الحجري القديم وباحتها المشجرة في بانياس حتى يومنا هذا، وتعد من أبرز المعالم القديمة والمعروفة في المدينة.
ويتحدث أحمد عن طريق مدرسته “زحلة الابتدائية” في حرستا عام 1970، مبيناً أن الطريق كان مأساة في الشتاء، كونه غير معبد، ولهذا اشترى أهله له ولأخوته “جزامي بلاستيك”، وكان يصل إلى المدرسة ببنطال كله وحل، والشيء الجميل وجود مدافئ على الحطب يشعلها مستخدم المدرسة لحين وصول الطلاب والأساتذة”.
ويشرح غانم عن مدرسته التي كانت في قرية أخرى، مدرسة كلماخو الثانوية، وقتها لم يوجد غيرها في المنطقة، فكانت الطريق صعبة معظم الأحيان ففي الشتاء مطر وفي الصيف شمس حارقة، إضافةً لطريق المدرسة الطويل الذي كان عليه قطعه يومياً، خصوصاً وأن المدرسة كانت 6 أيام في الأسبوع، مؤكداً أنها كانت ذكريات جميلة بوجود أصدقائه معه طول الطريق.
و يبين إياد أن مدرسته كانت سامي الدروبي في المالكي، وبيته في حرستا، ومن كان يصح له موطئ قدم على باص الهوب هوب “يكون أبو زيد خالو”، كان علي النزول في المرجة والمتابعة سيراً على الأقدام من ساحة الأمويين أمام مكتبة الأسد صعوداً إلى المالكي.
ويتابع إياد: “كان الأستاذ يرفض إدخالنا عند تأخرنا عن وقت الدوام المدرسي، وخوفاً من ردة فعل الأهل لم نعد إلى بيوتنا، بل كنا نجلس في مقهى الروضة، الأركيلة كانت بنصف ليرة والسمون بربع ليرة، طبعاً هنا نتحدث عن ذكريات عام 1977، أيام الثانوية الجميلة، كرحلة سياحة واستجمام”.
ويقول محمد، درست في دمشق، سامي الدروبي، أتذكر تناول الفلافل من “المصري” في البحصة، المرجة، مقابل بناء “يلبغا” حالياً، كما أذكر “كم الوجبة العجيبة” تذوقتها لأول مرة من مطعم “بدر”، اسمها “بوم فريت”، عام 1976، وكان سعرها أغلى من بقية السندويش، لنتفاجأ أنها مجرد بطاطا مقلية في صحن وعليها “كاتشب”، وبسعر 50 قرش”.
ولا يخفى على أحد ما شهدته سوريا خلال العقود الماضية من زيادة في عدد المدارس ووصلت إلى أكثر من عشرات الآلاف من المدارس، حيث أصبح لكل قرية ومربع سكني في أي مدينة مدرسة تخدم طلاب المنطقة، إضافةً لوجود مدارس متخصصة كمدارس الصناعات المهنية والفنون النسوية والمدارس الزراعية.
وتبقى لدروب المدرسة بصمة داخل كل شخص تجعله يبتسم عند استرجاعها، وذكريات عصية على النسيان نعيش تفاصيلها في كل مرة نسلكها بأشخاصها وأحداثها، ومن بعيد رجع لصدى صوت جرس المدرسة الذي يستعجل خطانا معلناً بدء يوم دراسي جديد بجملة “مجموع رتلاً ترادف”.