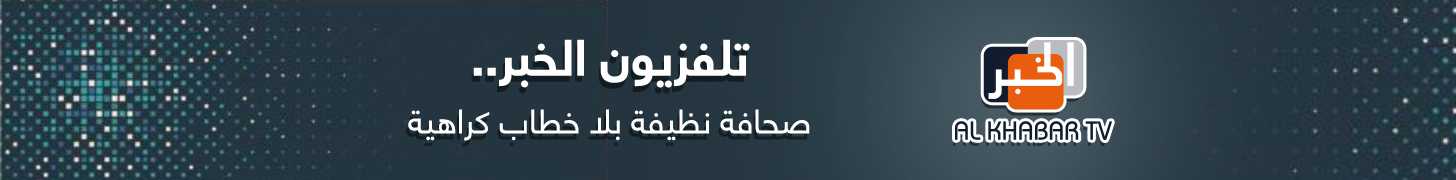أحياء حلب الشرقية تحاول قطع سلاسل الموت التي كبلتها

بين غياب الكاميرات والمراسلين، والتصريحات، تحيا أحياء حلب الشرقية، مستنفرةً كعادتها بأهلها، تسارع بإزالة ملامح الموت اليومي من شوارعها ، فيبدو المنظر كقتيلٍ، يحاول تغيير ملامحه ببعضٍ من “المكياج” .
في شوارع حلب بأحيائها الشرقية، بين الركام والأبنية الآيلة للسقوط، بهزة أرضية، ربما لن يستشعرها الحلبي، لكنها قد تودي بحياة الكثيرين الذين لم يجدوا ملجأً من الموت السريع إلا الموت البطيء .
على أطراف الشوارع المزال من بعضها، وبخاصة الرئيسي منها ركام حرب تركت سكان المنطقة اليوم على هامش الحياة، كما أسقطتهم يوماً خسائر جانبية على هامش الحرب.
حتى تلك التي تمت إزالة الأنقاض منها هي شوارع معظمها مليء بالحفر، تتحول إلى مستنقعات من الطين و”الوخم” بحسب التعبير الحلبي الواصف للحال بلسان معظم المارة فيها.
شوارع تحاصرها ذكريات الموت، بتفاصيل إن حكاها أهل المنطقة، ليس كما إن حكتها وسائل الإعلام، فبهذه المدرسة أعدم “فلان”، وفي حي الميسر مثلاً، سقطت قذيفة كانت لها خصوصيتها بين المئات غيرها، لأنها قتلت ما تبقى من أفراد عائلة، نجوا سابقاً من قذيفة أخرى سقطت أمام محل تجاري لهم في شارع فرعي من أحياء المدينة الغربية، وكأن لفنان الموت خطته في رسم لوحة الحرب في هذه المدينة.
تلك الأزقة تشارك قصص أبنائها، وتغنيهم عن شرح بعض التفاصيل، فأنت قادرٌ على ترجمة قصص الأهالي، بمناظر حيةٍ، فيقول أبو محمد “مر الموت من عنا، وما أخد مني غير الحوش وشوية حجار، ولادي بخير وبيرجع كلشي متل ما كان” .
فتشير لك إحدى المباني المهدمة لتشرح لك قصة أبو محمد، لتجد في أسفل بناءٍ من أربعة طوابق، قطعته الحرب كقطعة من “كيكة”، لم يعد يهم أحداً من أهله مصدر إطلاقها، ثلاثة أطفال يبيعون بعضاً من “الجبن البلدي”، هم أولاد أبو محمد، يجلسون بين ركام بيتهم، يبيعون “الجبن البلدي”، ويشترون أملاً بعودة حالهم الى سابق عهده.
لا يرسلهم أبو محمد للمدرسة اليوم لأنهم أغلى ما يملك بحسب قوله ولا نية لديه لإرسالهم لمدارس “بهذا البعد”، ويأمل بحسب تعبيره أن يتمكن من ذلك بعد عودة الحياة لطبيعتها في تلك الحارات.
“لا أضمن ألا يصابوا بأذى في طريق عودتهم أو ذهابهم الى المدرسة” الأنقاض في كل مكان والأبنية المهجورة تخيفني اليوم كما كان يخيفني تواجد المتطرفين في الحي، كنت أمنعهم من مغادرة المنزل الا برفقتي وأتمنى أن أشعر بالأمان الكافي ليعيشوا حياة طبيعية تنسيهم ما عاشوه من خوف” .
يتحول الزائر لأحياء حلب الشرقية فجأةً، الى شاعرٍ أضل الكلمات لكثرتها، فترتصف أمامه القصص متبارزةً، لينظم منها قصيدة رثاء أو هجاء، حسب ما يثيره من القصص، على عكس سكان المنطقة، التي غدت قصائد الشعر من هجاءٍ أو رثاء، واقعاً اعتادوا عيشه خلال سنوات الحرب.
ويشاهد الزائر مفارقات يحتاج بعضاً من الوقت لفهمها، فكيف تسقط المباني، وترتفع النفوس؟ وكيف للموت أن يحاصر مدينةً، وينقلب مُحاصراً فيها ؟
وكيف لركامٍ أن يتحول الى مصدر رزق؟ يأمل أصحابه أن يعيدوه كما كان، بعد أن ملوا من انتظار إعادة الإعمار التي كثرت وعوده وقلت مؤشرات بدئه. ليأتي تصريح رئيس الحكومة عماد خميس في الزيارة الأخيرة جازماً أن “اعادة الاعمار ستكون بأيادٍ وأموال سورية” .
تلك الأحياء تتحدث اليك بلغةٍ، دون أحرف، وأبجديةٍ أتقنها أولاد البلد فقط، وصارت لغتهم الرسمية، ففي حي الصاخور يصرخ الهواء المحمل ببقايا البارود، الى حي العرقوب ليخبره باقتراب “الزوار”، وينتقل الخبر بين المباني في كل المناطق، لتكشف كل الشوارع عن “عوراتها”، فهي ليست خجلة مما فعله الغرباء فيها.
ويضحك صاحب محل تجاري، في حي الحيدرية، لبيع “الليدات” والأسلاك، لا يتجاوز “رأسماله” 25 ألف ليرة، عند سؤاله عن سبب فتح مشروعه الجديد بهذا المكان، فهو متأكد من أنه لا جواب أفضل من أن “الناجي من حرب حلب، قادر على فعل كل شيء” .
ويلاحظ الزوار أن أغلب المحال التجارية هي للأطعمة الأساسية، والأدوات الأولية لاستجرار الطاقة الكهربائية والمياه، وأساسيات الحياة، التي فقدت لسنوات طويلة.
حلب التي أنهكتها الحرب، لمدة خمس سنوات، ودمرت آثارها وأحياءها، قادرة على تلخيص ما جرى، بمجرد جولة على الأقدام في أحد أحيائها، أو بقصة يرويها صاحب محل تجاري واثقٌ من أنه، التاجر الحلبي الذي يضرب به المثل، أو بابتسامة طفلٍ يدخل من بين الركام إلى ما تبقى من مدرسته، ليتعلم أن أبجدية الحرب هي ليست الوحيدة التي يقدر على تعلمها.
يزن شقرة – تلفزيون الخبر