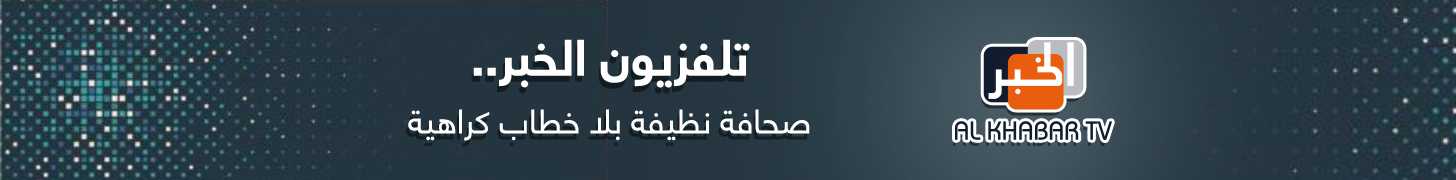الترند السوري .. الألم البيّاع وسياحة الكوارث

بالرغم من التناقض الظاهري بين كلمتي “سياحة و”كارثة” إلا أن الفكرة قديمة وتحاكي نزوعاً غامضاً أو متعدد المسارب عند البشر لمشاهدة الأماكن المدمرة، معاينتها والتقاط الصور بقربها.
وهذه الظاهرة ليست جديدة، ففي كل سنة يسافر ملايين البشر إلى الأماكن التي شهدت كوارث طبيعية أو بشرية، بدءاً من المناطق التي مرت عليها الأعاصير، البراكين، الزلازل وانتهاء بالمدن المنكوبة نتيجة الحروب والتفجيرات
فمثلاً بعد المسلسل الذي أنتجته نيتفليكس عن كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا، ازدادت نسبة السياحة في المنطقة بنسبة 40% وتعتزم الحكومة الأوكرانية تحويل المنطقة إلى مكان سياحي بالكامل رغم استمرار خطر الإشعاعات، إرضاء لـ”ذوق” الملايين من محبي “سياحة الكوارث” أو “السياحة السوداء”
وأذكر كيف كان الناس يستيقظون باكراً للذهاب إلى “ساحة الشيخضاهر” لمشاهدة إعدام أحد المجرمين كأنهم ذاهبون في نزهة.
وكما يمكن للصور التي تلتقط في المناطق المنكوبة أن تؤدي رسالة لتعريف الرأي العام بما يحصل وتكوين وجهة نظر عن الحدث/ الكارثة، يمكن أن ترضي هذه الصور النزعة الإنسانية بالتلصص على حيوات الأخرين، أو موتهم هنا
خصوصاً بعد موجة الدمار التي انتشرت مؤخراً في العالم العربي، وسهولة إنشاء الصور ونشرها، بعيداً عن التدقيق في محتواها أو في الغاية من استحضارها.
في الحرب السورية انتشرت العديد من “سيلفيات الكوارث”، لأشخاص عاديين أو لأشخاص معروفين وناشطين، ضمن أكوام الردم والبيوت المنهارة
واستشعر الناشطون هذه الرغبة عند الغربيين بالتلصص على حيواتنا وموتنا، طرق عيشنا وألمنا اليومي، وصاروا متخصصين ببهرجة الألم السوري، تصويره وتسويقه لدى المنظمات الحقوقية الدولية، والاسترزاق منه، تحت شعار “نقل الصورة الحية” أو “إظهار الحقيقة”، وأسفر الأمر عن” ترند” ساد لوقت طويل
وانتهت الآن موضته، ونسي الجميع السوري في مخيمات لجوئه ونزوحه، لأن التعامل مع المفرزات المرعبة للحرب السورية كانت موضة وانتهى وقتها، كما الكعوب العالية مثلاً أو البناطيل ذات الخصر المرتفع.
يأتي الناشط العربي أو الغربي ويتصور أمام مجموعة أطفال فقراء، نازحين، في أحد مخيمات اللجوء أو في المناطق المنكوبة، يرسل الصورة إلى مؤسسته أو ينشرها على صفحته، فيقبض ثمن ألمنا وفقرنا، عجزنا وخسارتنا، لايكات أو دولارات، ويرضي النزعة بالتلصص لدى “الخواجة” ويمسح على ضميره بمنديل معطر وانتهت الحكاية.
الموضة الآن هي التعاطف مع بيروت، ليس مع ضحايا الانفجار الذي حصل مؤخراً في المرفأ، بل مع بيروت كاسم غامض لمدينة ما، كأنها الأميرة في الأساطير، أو كأنها مفهوم منعزل عن البشر الذين يموتون كل يوم فيها، على أبواب المستشفيات، في مخيماتها وفي عنصريتها البغيضة.
بيروت – الرسالة، وكأنها حكاية مقدسة، لم تعمرها أيادي العمال السوريين والفلسطينيين، بل عمرتها يد الآلهة وبالتالي يجب أن ننوح عليها كما لم نفعل من قبل.
وبدأ الناشطون، الإعلاميون، الفنانون وكتبة المشاعر المجففة بشمس الفضيحة بتدبيج المراثي والقصائد والتقاط السيلفيات قرب البيوت المدمرة، ونسوا سوريا
إذ لم يعد عنوان “سوريا” يستجلب أي تعاطف، لم يعد الألم السوري بيّاعاً في صحف اليوم والمواقع الإلكترونية التي تعيش على الدم والانفجارات.
انتهت مفاعيل الدم السوري وانتهى المال المخصص للمقتلة السورية، رغم أن ما حصل في بيروت حصل في كل حي سوري على مدار عشر سنين من حرب هائلة، لكن صورة “أم أحمد” السورية، بفستانها الكالح وغطاء رأسها الممزق، أقل جاذبية من صورة “مس ليبان” بثيابها “الماركة” وإكسسواراتها اللماعة
وصورة دمار بيت سوري بدون دهان ولا “جمالية معمارية” أقل جذباً للحزن من دمار بيت بيروتي بسطح قرميد وقناطر.
الألم أيضاً “ترند”.
محمد أبو روز – تلفزيون الخبر