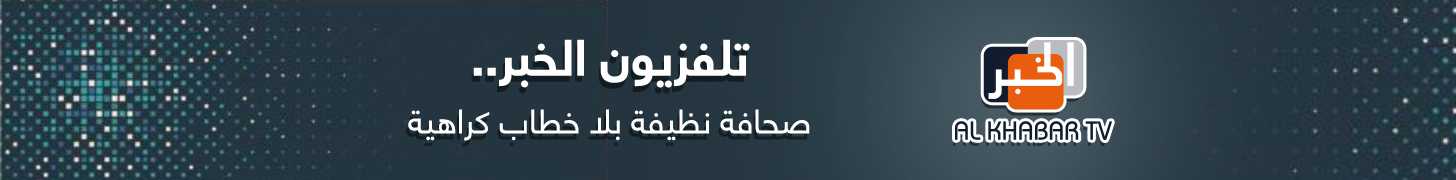أعياد السوريين وطقوسها المهددة بالاندثار

لا نعلم إن كان الحديث جائزاً عن العيد في أيام الحرب، وبرفقة كورونا، وقانون قيصر، ومفرزاتهم من فقر وحرمان وجوع، وفي ظل الفجوة المرعبة بين المداخيل “القزمة” مقابل الأسعار “العملاقة”.
وفي ظل هذه الظروف لم يبق شيء على حاله، فإن كانت المقارنة في السابق تتمحور حول وزن الأضحية بين العيد والعيد الذي يليه، الآن بتنا في أيام لا تستطيع فيها معظم العائلات أن تسد رمَق أفرادها، فما بالكم بالعزائم “العرمرمية”، والسكبات المهولة بكرمها، وضيافة العيد، والأضاحي، والعيديات، وغير ذلك مما بات في عداد المنسيات.
كثيرون باتوا يتشهُّون العودة إلى الماضي القريب، فقط قبل سنة، متجاوزين الرغبة بالرجوع إلى ما قبل عشر سنوات، إذ تغيرت الأحوال كثيراً في العام الماضي تحديداً، مما جعل عادات السوريين مهددة بالاندثار مع تغيّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية على مساحة الجغرافيا السورية.
على صعيد العزائم، والدعوات على وجبات الغداء أو العشاء، جميعها أصبحت من المنسيات إذ مع تموضع معظم السوريين تحت خط الفقر، وكون معظمهم مهدد بالجوع، أصبح من المستحيل بقاء هذه العادة، حتى الاجتماع في بيت العائلة أول أيام العيد بات صعباً جداً، لاسيما أن تكاليفه تفوق طاقة “الجيبة” مهما كان اتساعها.
وبعد أن كانت بيوت السوريين تمتلئ في العيد بالمعمول، والموالح الفاخرة، والحلويات المصنوعة بالسمن العربي، فضلاً عن صحن الفواكه المشكلة، والدخان من عدة أنواع،… فإن ضيافة العيد تقلَّصت إلى الحد الأدنى، حسب استطاعة كل عائلة، وأمسى المشهد القديم لطاولة الضيافة العامرة في خبر كان.
وفي الماضي كان العائلات السورية على موعد مع الأطعمة الدسمة في العيد، من الكبب والمحاشي، إلى جانب “السَّكبات”، وتوزيع لحومات الأضاحي، مما يضفي غنىً فوق غنى الأطباق المُجهَّزة لهذه المناسبة، أما الآن فيا حسرة، أصبحت اللقمة مغمسة بالدم، ونسي معظم السوريين طعم اللحم الأحمر وفي طريقهم لنسيان الأبيض منه.
أما السكبة فيحاول كثيرون المحافظة عليها لما لها من دور في توطيد العلاقات مع الجيران والأقارب، وتبقى على اختلاف محتوياتها ذات قيمة معنوية، يرى البعض أنها من العادات الجميلة التي لا ينبغي لها أن تفارق المجتمع السوري، ولو كانت تلك السكبة عبارة عن صحن مجدرة لا أكثر.
وفيما يتعلق بالأضاحي، فإن أكثر النكات التي يتداولها السوريون اليوم متعلقة بخروف العيد، الذي يلف رجلاً على رجل، متأكداً أنه بات ملكاً في هذه المناسبة، لا يقربه إلا الأثرياء، فسعره لا يقل عن الثلاثمائة ألف ليرة سورية، بينما كان في متناول الأغلبية بما فيهم الموظفون.
أما العيدية فباتت تُعطىً خجلاً، ودرءاً لكسر خاطر الأطفال المعتادين عليها، في حين أن هناك الكثير من الأهالي ألغوا هذا التقليد كي لا يحرجوا الأعمام أو الأخوال… في ظل ضيق الحال وقصر ذات اليد، حتى أنه في كثير من الأحيان أصبح حتى زيارات الأقارب شبه معدومة للأسباب الاقتصادية المتردية ذاتها.
وبسبب الخوف من التجمعات ومن توفير بيئة لانتشار كورونا، فإن الزيارات قلَّت، والتجمهرات حول ألعاب العيد باتت بالحدود الدنيا، مثلها مثل ملابس العيد وأسعارها الكاوية، لدرجة أن كثير من الأطفال باتوا يطلبون من أهلهم عدم شراء ذاك القميص أو ذاك الحذاء أو ذاك الفستان بعدما يعلمون أسعارها.
فإن كان الصغار كبروا في هذه الحرب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية، فما بالكم بالكبار الذين لم يبق أمامهم سوى التحسر على ما مضى، متمنين عودتها بحنين شاهق، ودموع مخفية لا تبتغي زيادة أوجاع هذه الأيام.
بديع صنيج- تلفزيون الخبر