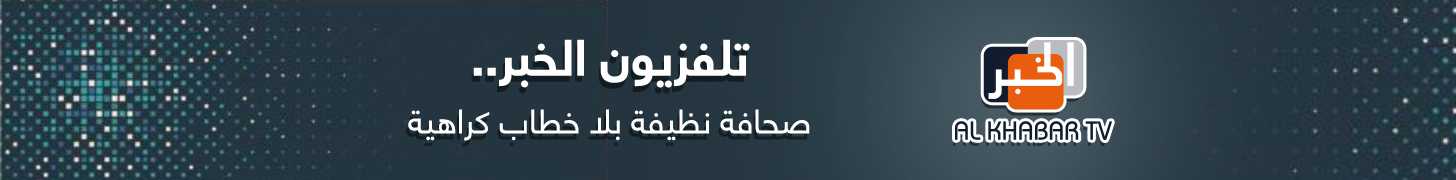في ذكرى رحيله الرابعة عشر.. ما يزال “محمد الماغوط” ترجمان النبالة

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الشاعر محمد الماغوط (1934-2006)، فنستعيد معها نبل صاحب “حزن في ضوء القمر” وأصالة حساسيته وحنان بؤسه وجماليات زوايا التقاطاته الفكرية شعراً ودراما ومقالات.
“البدوي المشعَّث” كما وصف نفسه، استطاع أن يُشذِّب بؤسه وأحزانه وغرفه التي بملايين الجدران، صائغاً منها صوراً مفاجئة وقصائد مفعمة بالدهشة، بعدما ينتشل الكلمات المهملة ويغلِّفها بحنانه الفائق وسحر موسيقاه.
ظل الشعر بالنسبة لصاحب “سياف الزهور” إنقاذاً له من ضيقه وتراجيدياته، ولعل امتزاج معظم ما كتب بتوابل السخرية المرة كانت بمثابة تميمة تحميه من بؤسه القاتل وتهويمات الأحزان والقهر المتغلغل في فكره وخلاياه كلها.
المميز في شعر “الماغوط” أنه “ظلّ نبيلاً خارج الموضوعات النبيلة بالمعنى التقليديّ”، كما تقول الناقدة “خالدة سعيد”، كما أنه اخترق سلَّم القيم التقليدية والعبارات المنمقة والمعايير الجمالية والبلاغة بإطارها الجامد، فجاءت قصائده بلغة جديدة تستمد نبلها العفوي من الهامش بلا إسفاف.
ولا يقتصر تميزه في الخروج عن الأوزان والإيقاع التقليدي والبلاغة الموروثة وحسب، بل كان نصير المُعذَّبين وكأنه كثَّف آلام المُهمَّشين ووكَّل لغته للدفاع عنهم وعن قضاياهم، فاتحاً في كل جدار نافذة.
يقول الماغوط: “وجوهُنا المختنِقةُ بالسعال الجارح.. تبدو حزينةً كالوداع.. صفراءَ كالسلّ.. ورياحُ البراري الموحشة.. تنقل نواحَنا.. إلى الأزقّة وباعة الخبز والجواسيس.. ونحن نعدو كالخيول الوحشيّة على صفحات التاريخ”.
واستطاع الماغوط أن يعزل نصه الشعري، عن مناظرات فكرية غزت غيره من أبناء جيله، واستوطنت لغتهم وصورهم الشعرية. فمع هؤلاء، كان الشعر والتفكير بالشعر، يتّحدان، ويتعثر معهما الإحساس بلحظة شعرية خاطفة، هي تيمة التجربة التي لا يجب أن يعطّلها التفكير الشعري عن الحدْس ومواجهة العالم.
أمّا مع صاحب “الفرح ليس مهنتي”، فما كان للتفكير بالشعر أن يعرقل نبض القصيدة. الأخيرة لديه جزء من جسده، تخرج مع أنفاسه وتقلّده ويقلّدها. وما سمح، أبداً، لصراع الأفكار في ستينيات القرن الماضي، أن يحجبه عن صوته.
يقول في أحد حواراته: “لماذا كل هذا التنظير للقصيدة؟ وماذا يعني القارئ إن وضعت كلمة أو حرفاً على يسار حرف أو نقطة على خصر نقطة، إذا كانت السجون والمستشفيات والأرصفة تغص بروّادها؟”.
وكما خرج شعر الماغوط عن المألوف في الفضائل والتقاط مكامن الجمال من البؤس والأرصفة، استطاع مسرحه أيضاً أن يلامس المُستضعفين، راسماً تراجيدياته الخاصة بنكهة لاذعة من السخرية لأصحاب السلطة والقرار، فتبدو الخشبة بانوراما من الألم المُناضِل في زمنه الحاضر المستمر.
ويرتكز مسرح صاحب “كاسك يا وطن” على “جعل البؤس ترجمانَ النبالة” بحسب الناقدة سعيد، إضافة إلى النبرة المثالية الوطنية، الممزوجة بالاحتجاج والغضب، والمتدثِّرة بحزن غاضب، يُحدّق في تناقضات الواقع ومآسيه، بلغة تمزج الابتسامة مع الدمعة المدرارة.
وفي ظل هذه الشخصية الأدبية التي تركت أثرها في كل ما يحيط بها، شعراً ونثراً وتصريحات وأسلوب حياة، تعرف القراء، وشغفوا بـ”حزن في ضوء القمر” 1959 و”غرفة بملايين الجدران” 1960 و”الفرح ليس مهنتي” 1970. هذا فضلاً عن مسرحياته وأشهرها “غربة” و”كاسك يا وطن” و”ضيعة تشرين”، وللسينما كتب “التقرير” و”الحدود”.
بديع صنيج- تلفزيون الخبر