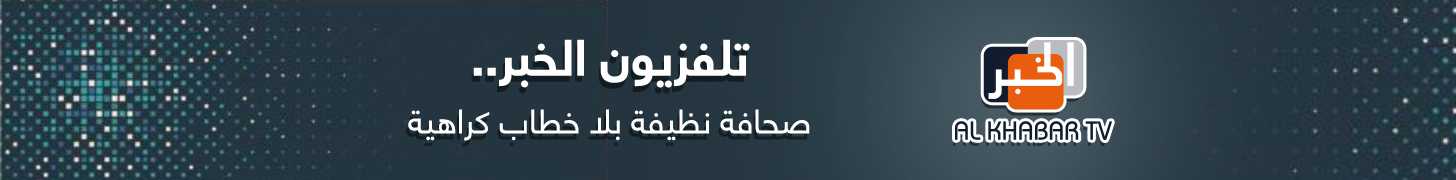في ذكرى رحيله السابعة والثلاثين.. “رياض الصالح الحسين” عرف كيف يقول وداعاً

“أنا رياض الصالح الحسين.. عمري اثنتان وعشرون برتقالة قاحلة.. ومئات المجازر والانقلابات.. وللمرة الألف يداي مبادتان.. كشجرتي فرح في صحراء” هكذا عرَّف صاحب “خراب الدورة الدموية” عن نفسه في أول دواوينه الصادر عام 1979.
وتابع في مجموعته “وعل في الغابة” التي صدرت بعد وفاته: “أنا حيوان جريح في غابة.. أنا زهرة متعبة، أنا وحش من العصور القديمة.. طفل لم أحفظ دروسي”.
وُلِدَ رياض الصالح الحسين في مدينة درعا في 10/3/1954 لأب موظف بسيط من مدينة مارع شمال حلب، منعه الصم والبكم الذي بدأ معاناته منهما في سن الثالثة عشر من إكمال دراسته، فدأب على تثقيف نفسه بنفسه، واضطر إلى ممارسة العمل مبكراً، كعامل وموظف وصحفي، وبقي مستمرّاً في كتابة الشعر والمقالات منذ عام 1976 حتى وفاته في 21/11/1982.
لم تكن كتابة القصيدة بالنسبة لرياض حالة ترفيهية، إنما حاجة روحية، وتفردت تجربته بتعاطيه الطفولي مع معطيات الحياة، ما جعل لغته مفعمة بالعفوية والبراءة، وفي الوقت ذاته بالفرادة في إحساسه بما حوله، فأبسط الأمور كانت تقلقه وتُذهِب النوم من عينيه، وكان إنقاذه بالشعر وحده.
الشعر بالنسبة لصاحب “أساطير يومية” هو صديق عتيق يلجأ إليه ليبثّه أحزانه وآلامه، وهو ما أزال أي فارق بين الإنسان والشاعر، لدرجة أنه يوطِّد علاقته بالحياة من خلال تغليف قلقه واغترابه بقصائد من النوع الشفيف المنتمي إلى “السهل الممتنع”.
يقول في قصيدته “غرفة الشاعر”: “يفتح بابَ الكلماتِ ويدخلُ بخطىً خائفةٍ.. في أنحاءِ الغرفةِ.. بعض قصائد ذابلة.. كلمات تتمدد فوق الكرسيّ.. وأخرى تتعلّق بالمشجب.. نبلة تهرب من بين أصابعه.. وطيور تقتحم الشفتين..
يرى عشباً ينبت في المكتبةِ المهملةِ.. ونبعًا ينبثق من الحائط.. بعد قليل سوف يداهمه الليل بأقمار وكوابيس.. تداهمه أشجار الغابة.. ورمال الشاطئ.. وحصى الأنهار.. وآبار فارغة.. يملؤها بحروف سوداء.. ماذا يأخذ من جثث الأيام.. وماذا يترك غير قصائد ذابلة.. وغبار الكلمات؟”.
عانى رياض كثيراً من قسوة الحياة، ونتيجة ذلك تنامى إحساسه بضرورة الشعر كملجأ، فهو الوحيد القادر على إنقاذه من عذاباته وفوضاه ويأسه، وبالشعر استطاع أن يحافظ على جوهر بساطته وعفويته، كما استعان بصداقات العديد من الشعراء منهم: نزيه أبو عفش، بندر عبد الحميد، ومنذر المصري وغيرهم ممن كان لشعرهم تأثيره الكبير.
ومع كل معاناة رياض بقي للحب حضوره الآسر، الذي يعينه على مكابداته، ولشدة إحساسه الصادق بالحب كان يشبِّهُه بكذبة جميلة، إذ قال في إحدى قصائده: “من أكاذيب الكلام.. من أكاذيب الروائح.. من أكاذيب الأصوات.. من أكاذيب العالم.. الكذبة الوحيدة التي تستحق التصديق.. هي الحب”.
وفي لحظة إشراق أحس الشاعر باقتراب مصيره الذي قاومه بكل ما امتلك من قوة، فكتب قصيدة وداع تعبر عن حالته جاء فيها: “ها أنذا أمشي وأمشي.. بين هزائمي الصغيرة وانتصاراتي الكبرى.. وها أنذا أمشي وأمشي.. متألقًا كنجمة في السماء.. وحُرًّا كوعل في الغابة.. لي وطن أحبه وأصدقاء طيّبون.. بنطال وحذاء وكتب ورغبات.. ووقت قليل للرقص والجنون والقبلة.. لقد بدأت أتعلم كيف أبتسم وأقول وداعاً”.
انحاز رياض الصالح الحسين إلى الحياة بتفاصيلها المؤلمة، وعبّر من خلال قصائده اليومية عن قلقه الوجودي بلغة تناوبت بين الفرح والحزن، بين الأنا الواعية للنحن المكلومة، وبين حاضر الشعر وقدرته على البقاء في زمنه الحاضر المستمر.
وقبل أن يلملم صاحب “بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس” بقاياه خاطب سوريا التي كانت آنذاك تعاني من محنة الثمانينات بقصيدة قال فيها: “يا سوريا الجميلة السعيدة.. كمدفأة في كانون.. يا سوريا القاسية كمشرط في يد جراح.. نحن أبناؤك الطيبون..الذين أكلنا خبزك وزيتونك..
أبداً سنقودك إلى الينابيع.. أبداً سنجفف دمك بأصابعنا الخضراء.. ودموعك بشفاهنا اليابسة.. أبداً سنشق أمامك الدروب.. ولن نتركك تضيعين يا سوريا.. كأغنية في صحراء”.
تلفزيون الخبر