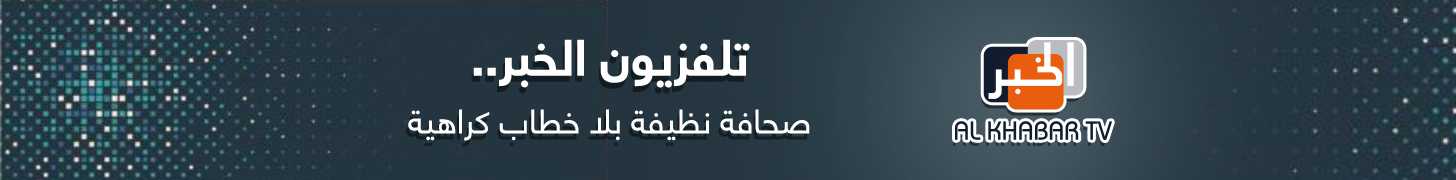عندما يتدفَّأ السوريون على “الحنين”!

“هل تتذكر عندما كان ليتر المازوت بسبعة ليرات وربع؟” سؤال يحمل الكثير من الألم والحزن والخذلان والوحشة، وبرغم قسوته إلا أنه يؤجج نيران الحنين لأيامٍ مضت، فتصبح الذكريات سبيل السوريين الوحيد للدفء، بسبب سوء الحال عموماً، وبعد ارتفاع سعر الليتر الواحد من المازوت ما يُقارب الأربعين ضعفاً خلال تسع سنوات.
مَنْ مِنَّا لا يتذكَّر شجاراتنا المديدة مع إخوتنا حول من سيحتلَّ الرُّكْنَ الأثير “تحت كوع الصوبيا”، لأن ذاك المكان استراتيجي، وفيه مزايا عديدة، تبدأ بالدفء الزائد، ولا تنتهي عند إمكانية استخدام المدفأة لتسخين “إبريق المتة” مثلاً دون الحاجة لتغيير المكان.
إنه رُكْنُ مُحبي “الكَنْكَنة” والاسترخاء الذي يصل إلى مرحلة “الاستواء الكامل”، وتُشيرُ إليه حُمرة الخدود الطافحة، وذبول الأجفان، اللذين يوديان بصاحبهما إلى بعض الحروق الطفيفة الناجمة عن الإغفاء، والتصاق أحد الأطراف، أو الوجه مثلاً، بالمدفأة، كإشارة إلى ضرورة الاتجاه إلى التخت للنوم.
تحوُّلُ “الصوبيا” إلى مركز جذب، تُحقِّقه أسبابٌ أخرى، منها أيضاً، إمكانية تدفئة الجوارب تحتها، بحيث إنك بعد ارتدائك لها ستشعر أن قدميك باتتا “مثل النَّار”، هذا فضلاً عن موسيقى تأجُّج النيران القادرة على نقلِكَ، نفسياً على الأقل، من عزِّ كوانين إلى آب اللَّهاب.
الموضوع لا يقتصر على الموسيقى فقط، بل إن ألسنة اللَّب قادرة على إغوائك برقصاتها ذات التشكيلات غير المنتهية، لدرجة أنك لن تشعر بالملل مع كل هذا الجَمال، خاصةً مع اللون الأزرق للَّهب دلالةَ نظافةِ مازوت التدفئة على عكس ما نراه الآن.
يقول “غاستون باشلار” في كتابه “النار في التحليل النفسي”: “تتيح لنا النار المناسبة لذكريات لا تنالها يد البلى، وأيضاً لاختبارات شخصية، بسيطة، حاسمة، ولذلك النار ظاهرة ذات امتياز يمكِّنُها من تفسير كل شيء”.
يعيش السوريون في أيام البرد الآن ذكرياتهم عن تلك الاختبارات التي تحدث عنها “باشلار”، لكن من دون أن يصلوا إلى تفسير علمي لقدرتهم على تحمُّل كل ذلك الألم.
ويضيف “غاستون”: “النار تتصاعد من أعماق الجوهر وتتبدَّى لنا حُبَّاً، ثم تعود وتهبط إلى قلب المادة وتختفي كامنة، منطوية، كالحقد والانتقام، وهي الوحيدة التي تتقبل قيمتي الخير والشر معاً”.
يتأمل الكثيرون في سوريا هذه الجملة، ويُصادقون عليها، مع تعليق جماعي كجوقة من الوَجَعْ: كل الحُبّ الذي تُبديه النَّار صار سجيناً للماضي التَّام الأركان، أما هبوط النار وانطوائها على الحقد والانتقام فنعيشه في أبهى حالاته في الزمن المضارع المستمر.
النار بحسب الفيلسوف الفرنسي “باشلار”، “تتألق في الفردوس وتستعر في الجحيم، عذوبة وعذاب، مختبر بداية ورؤيا نهاية، هناءة واحترام، ويمكن أن تتناقض مع نفسها، لذلك فهي ابنة مبادئ التفسير العالمي”.
جميع السوريين عاشوا تجاربهم الشخصية مع النار، بكامل انعكاسات تلك التجارب، من الحب إلى الكراهية، وبين الودّ والنُّفور، ولعلَّ أكثر تلك التجارب قسوةً هي أن تعيش في وسط لهب الحرب ولا نار لتدفِّئك، ولا سبيل لذلك سوى الحنين.
من منكم يستطيع نسيان رائحة الخبز المُقرمَش على جسد “الصوبيا” المستدير، أو طعمُهُ الذي لن تستطيع أفخم الأفران سياحية كانت أم احتياطية تحقيقه؟ وهل تتذكرون طعم البطاطا المشوية داخل المدفأة، ورائحة قشور البرتقال التي تُعطِّر الجَّوّ أفضل من كل المُعطِّرات الحديثة.
وهل هناك أطيب من طعم الشاي “الخمير والفطير” وهو يتخمَّر منذ العودة من أماكن العمل والدراسة وحتى المساء؟ والأجمل عندما تُزاوجه بطعم الكستناء وأصوات “طقطقة” قشورها وأزيز زيتها على معدن “المدفأة”.
كما أن المدفأة تُحوِّل ليلَ من حولِها إلى مسرحٍ لخيال الظل، يكبُرُ فيه الرأس على الحائط المُقابل فيصبح غولاً، وتستطيل الأصابع طيورَ شَوْق، وتتحوَّل المساءات إلى مُخايلين وخيالات، مع تنويعات كبيرة للفرح والدَّهشة والألفة، لكن للأسف بات الكثير من السوريين الآن على عتبات نسيانها.
بديع صنيج- تلفزيون الخبر