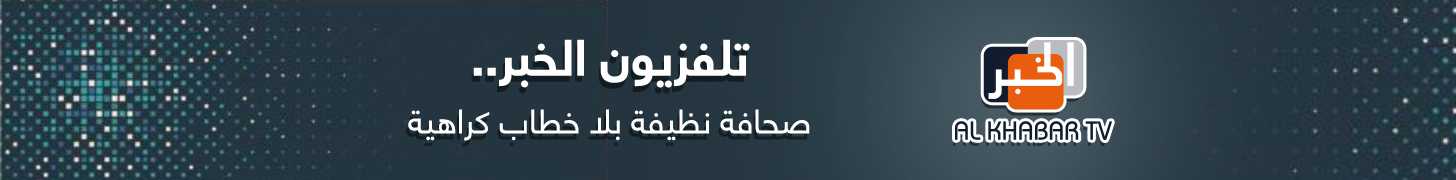مما كتب وقال نزار قباني .. في ذكرى وفاته

كتب نزار سنة 1970
في التشكيل العائلي، كنت الولد الثاني بين أربعة صبيان وبنت، هم المعتز ورشيد وصباح وهيفاء، أسرتنا من الأسر الدمشقية متوسطة الحال، لم يكن أبي غنياً و لم يجمع ثروة، كل مدخول معمل الحلويات الذي كان يملكه كان ينفق على إعاشتنا وتعليمنا وتمويل حركة المقاومة الشعبية ضدّ الفرنسيين.
وإذا أردت تصنيف أبي أصنفه دون تردد بين الكادحين، لأنه أنفق خمسين عاماً من عمره يستنشق روائح الفحم الحجري ويتوسد أكياس السكَّر، وألواح خشب السحاحير، وكان يعود إلينا من معمله في زقاق (معاوية) كلَّ مساء، تحت المزاريب الشتائية كأنه سفينة مثقوبة..
وإني لأتذّكر وجه أبي المطلي بهباب الفحم، و ثيابه الملطخة بالبقع والحروق كلّما قرأت كلامَ من يتّهمونني بالبرجوازية والانتماء إلى الطبقة المرفهة والسلالات ذات الدم الأزرق.
أي طبقة.. و أي دم أزرق.. هذا الذي يتحدثون عنه؟
إن دمي ليس ملكياً، ولا شاهانياً، وإنما هو دم عادي كدم آلاف الأسر الدمشقية الطيبة التي كانت تكسب رزقها بالشرف والاستقامة والخوف من اللّه.
وراثياً، في حديقة الأسرة شجرة كبيرة ..كبيرة .. اسمها أبو خليل القباني، إنه عمّ والدتي و شقيق جدّ والدي .. قليلون منكم_ربّما_ من يعرفون هذا الرجل، قليلون من يعرفون أنه هزّ مملكة، و هزَّ باب (الباب العالي) و هزَّ مفاصل الدولة العثمانيَّة، في أواخر القرن التاسع عشر.
أعجوبة كان هذا الرجل، تصوَّروا إنساناً أراد أن يحول خانات دمشق التي كانت تزرب فيها الدواب إلى مسارح .. ويجعل من دمشق المحافظة، التقيّة، الورعة..(برودواي) ثانية .. خطيرة كانت أفكار أبي خليل .. و أخطر ما فيها أنه نفَّذها .. و صُلب من أجلها..
و أنا أيضاً ضربتني دمشق بالحجارة والبندورة والبيض الفاسد..حين نشرتُ عام 1954 قصيدتي (خبز و حشيش و قمر)، العمائم نفسها التي طالبت بشنق أبي خليل طالبت بشنقي .. والذقون المحشوّة بغبار التاريخ التي طلبت رأسه طلبت رأسي.. (خبز و حشيش و قمر) كانت أول مواجهة بالسلاح الأبيض بيني و بين الخرافة..و بين التاريخين..
دارنا الدمشقية: لا بدَّ من العودة مرةً أخرى إلى الحديث عن دار (مئذنة الشحم) لأنها المفتاح إلى شعري، والمدخل الصحيح إليه، وبغير الحديث عن هذه الدار تبقى الصورة غير مكتملة، ومنتزعة من إطارها.
هل تعرفون معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر..؟ بيتنا كان تلك القارورة، إنني لا أحاول رشوتكم بتشبيه بليغ، ولكن ثقوا أنني بهذا التشبيه لا أظلم قارورة العطر .. وإنما أظلم دارنا، والذين سكنوا دمشق وتغلغلوا في حاراتها وزواريبها الضيقة يعرفون كيف تفتح لهم الجنة ذراعيها من حيث لا ينتظرون ..
بوّابة صغيرة من الخشب تنفتح ويبدأ الإسراء على الأخضر والأحمر والليلكيّ وتبدأ سمفونية الضوء والظّل والرخام، شجرة النارنج تحتضن ثمارها، والدالية حامل والياسمينة ولدت ألف قمراً أبيضاً وعلقتهم على قضبان النوافذ ..وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا..
أسود الرخام حول البركة الوسطى تملأ فمها بالماء، وتنفخه، وتستمر اللعبة المائية ليلاً و نهاراً .. لا النوافير تتعب .. ولا ماء دمشق ينتهي .. الورد البلديّ سجَّاد أحمر ممدود تحت أقدامك .. واللَّيلكَة تمشط شعرها البنفسجي والشِمشير والخبَّيز.
القطط الشامِّية النظيفة الممتلئة صحةً و نضارة تصعد إلى مملكة الشمس لتمارس غزلها ورومانتيكيتها بحريّة مطلقة، وعشرون صحيفة فلّ في صحن الدار هي كل ثروة أمي،
كلُّ زّر فّلٍ عندها يساوي صبيّاً من أولادها.. لذاك كلما غافلناها وسرقنا ولداً من أولادها..بكتْ..و شكتنا إلى الله.. ضمن نطاق هذا الحزام الأخضر .. و لدتُ وحبوت ونطقتُ كلماتي الأولى.
و في “الموت الأخير” .. قال نزار قباني:
“هذا هو الحد الأقصى لجنوني .. ولم أعد أقدر أن أحبك أكثر.. هذا هو المدى الأخير لذراعي .. ولم أعد أستطيع أن أضمك أكثر .. هذه آخر معركةٍ أدخلها .. للوصول إلى نوافير الماء في غرناطة .. ولم يعد بوسعي أن أقاتل أكثر .. هذا آخر موتٍ ..أموته مع امرأة .. ومن أجل امرأة .. ولم يعد يمكنني أن أموت أكثر ..”.
إذ عاش نزار قباني آخر سنوات حياته في لندن وودع دمشق في زيارة أخيرة قبل أن يرحل عن عالمنا في لندن في الثلاثين من نيسان عام 1998، وعاد إلى دمشق مجدداً لكن هذه المرة كجثمان محمول بالطائرة، و أوصى نزار قائلا ً: “أدفن في دمشق، الرحم التي علمتني الشعر والإبداع، وأهدتني أبجدية الياسمين”.
روان السيد – تلفزيون الخبر