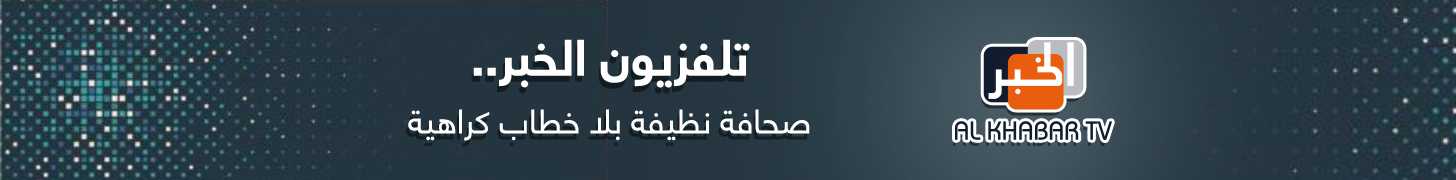“غيرلي حالي التقنين”..هكذا تغيرت حياتي بدون كهرباء

يعيش السوريون في هذه الأيام، واحدة من أقسى مراحل الأزمة، والتي حلت ضيفاً ثقيلاً علهم، منذ أكثر من 10 سنوات.
وتضرب الأزمة اليوم عدة مناح من معيشة السوريين، بداية من قدراتهم الشرائية، وصولا إلى توافرية متطلبات المعيشة، وربما ليس انتهاء، بانقطاعات الماء والكهرباء الكبيرة.
ووصلت ساعات التقنين الكهربائي إلى مستويات قياسية في معظم البلاد، وبلغت في اللاذقية مثلا، معدل4 ساعات كهرباء فقط باليوم، وذلك لأيام كثيرة منذ حلول الصيف.
ولأن الأزمات تفرض على الناس طرقا متنوعة للتأقلم معها، كان لابد من رفع شعار “التغيير”، ليضرب معظم سلوكياتنا اليومية، ليتسنى لنا العيش بحسن جوار، مع سعادة التقنين.
أنماط سلوك كثيرة فرضتها زيادة ساعات التقنين في حياتي، لم أكن لاعتد عليها في الصيفيات السابقة، تبدأ من ساعات الصباح الأولى، ولا تنتهي إلا في مساء كل يوم.
فلولا انقطاع الكهرباء المستمر ليلاً، والذي يصل إلى 5 أو 6 ساعات، أثناء ساعات “الراحة والنوم”، لم أكن لأفتح شباك الغرفة طول الليل، طمعاً في القليل من الهواء اللازم لاستقرار “الغفوة”، دون اعتبار لخلو شباك منزلي من “المنخل”، و “خلي البرغش يفوت صحتين ع قلبو”.
30 سنة ونيف، لم أكن فيها لآخذ حمامي الصباحي، بالماء البارد، لولا غياب الكهرباء الطويل عن السخان، الماء الساخن بات تراثا بالنسبة لي، وعند الضرورة أسخن الماء على الغاز، “مع البسملة والترقية لتضاين الجرة حتى توصل الرسالة”.
وبفضل غياب الكهرباء الطويل عن الغسالة، وزيادة عمر وجبة الغسيل لتصبح أكبر من وجبة “كنتاكي”، لابد لضمان توافرية ملابس نظيفة بشكل يومي، من غسلها على يدي، بدلا من وضعها في قائمة الانتظار كما جرت العادة، في سلة الغسيل.
ويفرض تباين ساعات التقنين بين منطقة وأخرى نفسه على مخططاتي اليومية، فمديري بات مسرورا مني لقدومي للعمل قبل الدوام بساعة، وخروجي منه بعد انتهاء الدوام بساعة، وهو ليس التزاماً بقدر ما هو استفادة من الكهرباء في وقت يكون فيه التقنين حاضرا بذات الساعتين في المنزل.
وعند انقطاع الكهرباء ل4 او 5 ساعات متواصلة ليلا، ومع موجة الحر الشديدة، لابد من حيل معينة للتذاكي على “الشوب”، ولكون السوري اليوم لا يستطيع كما السابق النزول يوميا للمقاهي، أجلب كرسيا من المنزل، وأجلس منتصف الحي.
لست وحدي من يجلس في الشارع، فكثيرون مثلي أيضاً، حيث تعرفت على جيران جدد ربما طوال سنين سابقة لم يجمعني بهم سوى “المرحبا”.
وفي الحديث عن المقاهي، بات هنالك معياران أساسيان لانتقاء المقهى الذي سنجلس فيه على خلاف الأوقات السابقة حينما كنا نبحث عن أطيب أركيلة أو أدق شاشة، “لأنو مو محرزة نروح عالقهوة وندفع، إلا إذا في تكييف وشحن للجوال”، أو على الأقل طاولة في الهواء الطلق ليلاً.
أما في حال قررنا البقاء في المنزل لسبب أو لآخر، فيبدو أن الأمور متجهة نحو بيع طقم الكنبايات، والاكتفاء ببعض “الطراحات” لنسند عليها ظهورنا، ونحن نجلس على البلاط البارد نسبيا، “الكنباية بتبخ نار” والبلاط بات ملجأ للجلوس وحتى للنوم.
كذلك بفضل التقنين، تصالحت مع فكرة شرب الماء من البراد، حيث كان الماء البارد لا يرويني بل يزعجني، والآن بفضل غياب الكهرباء لساعات عن البراد، بات برودة المياه مقبولة، و”بتروي العطشان”.
وبفضل التقنين أيضاً، لم أعد أستسيغ الكولا والعصير لأن الحصول عليها باردة بات بحاجة إلى معادلة، واتجهت “للسلاش المثلج” طمعا ببعض البرودة.
سابقا، لم أكن أذهب للملعب مثلا إلا لمتابعة فريقي المفضل، واليوم باتت “روحة الملعب” بحثا عن بعض الهواء الطلق ليلا، في الاستاد الذي يتحول مساء ل”مشلق هوا”، و”مو مهم مين عم يلعب مع مين المهم الهوايات”، من الأولويات.
هكذا “غيرلي حالي الهوا”، وغير التقنين في حياتي الكثير، ألا يقولون بالتغيير ننال التيسير، هكذا أصبحنا أكثر مرونة وديناميكية، كل تلك الصفات الإيجابية، أساسها “غياب التوريدات، الحصار، الأعطال، الفاز، والخ من مصطلحات التقنين ومسبباته.
صيفية 2021 تعيش الشهرين الأخيرين من عمرها، ومع نهايتهما أودع تجربة مريرة مع التقنين، إلا أنها تجربة مفيدة على صعيد المرونة والتحايل على الهم، بانتظار ما ستجود علينا صيفية 2022، من تغييرات وتحولات، عل “الشمس” تفتح لنا فيها “طاقة” القدر.
تلفزيون الخبر