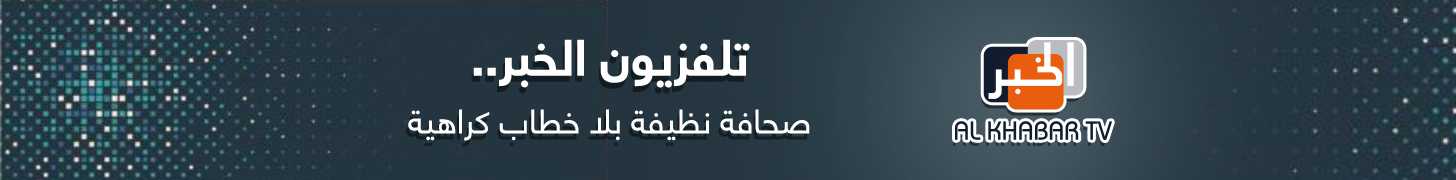كيف نشارك يومياً في زيادة خطاب الكراهية وتعميق الانقسام دون أن ننتبه؟

كيف نشارك يومياً في زيادة خطاب الكراهية وتعميق الانقسام دون أن ننتبه؟
يُعتبر انتشار خطاب الكراهية، خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها أي دولة مرّت بنزاعات عسكرية أو سياسية، من أكثر العوامل التي تُهدّد الاستقرار وتزعزع مسار المصالحة الوطنية. وفي سوريا، ساعد انتشار الأخبار المضللة وثقافة التنميط والتأطير عبر السوشال ميديا، واعتماد وسائل الإعلام على تضخيم الأحداث أو تقديمها بشكل مُبسّط أو مُحرِّض، في ظل غياب المهنية، على الوصول إلى مرحلة شيطنة الآخر واتساع دائرة العنف بين معظم الأطراف والمكوّنات.
تعاريف وأرقام
يُعرَّف خطاب الكراهية، بحسب “قاموس كامبريدج”، بأنه: “خطاب عام يُعبّر عن الكراهية أو يشجّع على العنف تجاه شخص أو مجموعة على أساس شيء مثل العِرق أو الجنس… إلخ”، ويُعرَّف أيضاً بأنه: “لغة أو رموز أو صور تُحقِّر أو تُجرِّد من الإنسانية أو تُحرِّض على العداء ضد أفراد أو جماعات على أساس سمات الهوية (مثل الدين أو الطائفة أو المنطقة أو الإثنية أو الجندر أو الرأي السياسي)، بما يُعمّق الوصم ويقوّض الكرامة والعيش المشترك”.
وبحسب استطلاع خاص بسوريا أجراه “المركز العربي للدراسات والأبحاث” ، فإن 85% من المشاركين يرون أن خطاب الطائفية منتشر في البلاد، ويعتقد 84% من المشاركين أن الناس هذه الأيام يُصنّفون أنفسهم والآخرين على أساس مذهبي وديني. كما يرى 83% من المستجيبين أن التمييز بين الناس على أساس مذاهبهم ودياناتهم منتشر في البلاد، بينما يعتبر 41% من المستجيبين أن التوتر بين المواطنين بحسب المذهب أو الدين هو نتيجة تدخلات جهات خارجية، مقابل 36% يرون أن التوتر نتاج غياب المواطنة والتسامح.
وكشف تحقيق استقصائي أجرته “بي بي سي” عن شبكات من الحسابات الخارجية تنشط على منصة “إكس”، تعمل على تأجيج الطائفية ونشر خطاب الكراهية، إلى جانب ترويج معلومات مضللة حول الأوضاع في سوريا.
الآن، بعيداً عن العوامل الخارجية، هل سألنا أنفسنا للحظة: هل نحن المشكلة؟ هل فكّرنا بأننا شركاء ومذنبون لا ضحايا؟ من منّا يُراقب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل يفكّر أحدنا أن تعليقًا بسيطاً أو نكتة قد تكون بذرةً للانقسام أو نواةً لسلوك عنيف أو إقصائي، حتى لو كانت عن حسن نية؟ وهل نواجه أنفسنا بسؤال: ما دوري أنا فيما يحدث؟
سلوكيات صغيرة أثرها تراكمي
مشاركة نكتة ساخرة عن جماعة معيّنة، أو إعادة نشر تعليق إقصائي، يبدو الأمر مجرّد مزحة أو حدثاً روتينياً، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن تكراره يومياً يصنع مناخاً عاماً من الاستهزاء، قد يُفضي إلى خطر كبير. هذه التفاصيل باتت جزءاً من يومياتنا كسوريين، نمرّ عليها كمشاركين أو مشاهدين، دون أن ندري ماذا سيحصل عند تراكمها في لاوعينا الجمعي والفردي.
تقول الأخصائية الاجتماعية روعة الكنج لتلفزيون الخبر “المزح أو التجريح المُغلَّف بالتهكّم، أو نقل أخبار غير مؤكَّدة، أو نشر محتوى مؤطَّر سلبي حول طائفة أو فكرة أو منطقة، يُغذّي التحيّز التأكيدي ويُعزّز تنميط الآخر. هذا كلّه مقدّمة لقبول العنف وخطاب التطرف، خصوصاً عندما نحصر أنفسنا ضمن مجموعة نسمع فيها صدى ما نريد. هنا تتحوّل الكلمة إلى فعل، ولا سيما عند الفئات المتعبة أو الضعيفة التي تبحث عن جهة أضعف منها لتُشعر نفسها بأنها أقوى. بمعنى أن البعض يترجم إحساسه بالظلم والقهر بالمشاركة في السخرية ضد فئات أخرى محور الهجوم، بينما الجهات الأخرى لا تصلها النكتة

أو السخرية بمعناها البسيط، بل تصلها على أنها غير مرغوب بها، وتجعلها تشعر بالتهديد الوجودي، فتتقبّل السخرية مقارنةً بالأسوأ، وللعلم الجرائم الكبرى تُبنى على أكتاف الأشخاص العاديين، حيث يرتكبون أخطاء صغيرة تُنتج شروراً كبيرة، سواء كان الشخص مشاركاً مباشراً أو متفرّجاً تخلى عن مسؤوليته”.
وتتابع الكنج “دورنا هنا هو ما يُعرف بـ(التواطؤ الصامت) و(أثر المتفرّجين)، فحتى سكوتنا رسالة نشارك بها في الظرف الحالي، على مبدأ أن الصمت حياد، لكنه موقف يسمح للتطرف أن يطفو. وهذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نرى بشكل نادر من يتحدث بأخلاقية وعدل، وحتى من يتحدث بهذا الأسلوب يتعرّض لهجوم كبير يجعله يتوقف عن المقاومة وينسحب، وهو ما يعقّد الموقف أكثر، ليس على الشخص وحده، بل على أهله وأولاده”.
من جهته يرى الناشط المدني حسين شبلي خلال حديثه مع تلفزيون الخبر أن “رصيد البشر اليومي من العنف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح كبيراً إلى حدٍّ يصعب معه الجزم: هل الجيل الحالي من البشر أكثر عنفاً من أسلافه؟ والحقيقة أن البشر لم يتغيّروا، لكن الوسط الذي يتحرّكون خلاله هو الذي تغيّر، فالبشر ليسوا آلات أخلاقية معصومة، بل كائنات قابلة للالتزام بالقواعد كما لخرقها، والفيصل هو الإطار والموقف. لذا تبدو أخلاقهم أكثر سيولة في عالمٍ افتراضي لا قواعد واضحة فيه للصواب والخطأ، عالمٍ يمنحك من الأقنعة ما يؤمّن لك التحلّل من أي مسؤولية عمّا يحدث، وكأن لا أحد يكترث لما تقول أو تفعل”.

ويردف شبلي “هنا يفقد الفعل الشرير واقعيته، بل صفته كفعل، ويصبح تهديد الناس واتهامهم أسهل من الاعتراف بالحب. لذا ترى يومياً تكرار تلك الممارسات التي تمهّد للإقصاء، من عمليات نزع الآدمية عن الآخرين عبر وصفهم بالشياطين أو القردة، ومن عمليات نزع العقلانية عن تصرّفاتهم ووصفها سلفاً بالخبث أو الغباء، هكذا نخلق صورةً كريهةً للآخر يصعب معها ألّا نرى بقاءه خطراً علينا، لتغدو عملية إقصائه في العالم الحقيقي مجرّد إحقاق للعدالة، دون أن نرى الدور الذي ساهمنا به ضمن الواقع الافتراضي عبر تهيئة ذواتنا لتقبّل ممارسة الشر بحق الآخر بعدما تمت شيطنته وإخراجه من الحلقة الآدمية. فصار العنف عدلاً، والكراهية مجرّد توصيف لا تنميط”.
من السلوك الفردي إلى المزاج العام
يرى كلّ سوري اليوم نفسه صاحب قرار ورأي ووجهة نظر في كلّ شيء، وهذا أمر جيّد في ظاهره حيث الحرية والقدرة. لكن في باطن الأمور، ربما يكون سلوك الفرد (كتعليق سلبي أو عنيف على سوشال ميديا) مرتكزاً لتأسيس مزاج عام عبر التتابع والتكرار. فعندما يتكرّر الفعل الفردي، يصبح جزءاً من لغة جماعية، ويُطبع العنف الرمزي دون أن نلحظ.
توضح كنج أنه “عندما يتكرّر الفعل الفردي يتحوّل إلى قاعدة اجتماعية، فكل المزحات والميمز والعبارات والأغاني تتحوّل إلى حقيقة اجتماعية واقعية. كما حدث زمن النازية، حيث كانت الكاريكاتيرات ضد اليهود عاملاً من عوامل ما حدث لاحقاً، أو في رواندا حين كانت هناك إذاعة تصف جماعة ما بأنهم “صراصير”، وهو ما سهّل إبادتهم. بمعنى أن السلوك عدوى اجتماعية، فخطاب الكراهية المنتشر يصبح رأياً سائداً وقابلاً للامتثال له خوفاً من العزلة الاجتماعية وردّة فعل الأغلبية المؤيدة لهذا الرأي (أغلبية صامتة معها أقلية متطرفة)، تصبح النتيجة قاعدة مجتمعية، خصوصاً من خلف شاشات الهواتف المحمولة، نظراً لسهولة إخفاء هوية ناشر الخطاب السيّئ”.
أما شبلي فلا يعتقد أن السلوك الجماعي هو حاصل مجموع أفعال أفراد الجماعة، بل العكس تماما، وينوه إلى أن “سلوك الجماعة هو الذي يخلق الأداءات الفردية ويغدو نمطاً لا بدّ للفرد من التماهي معه. فكلّ فرد يخشى نبذه وتهميشه، ويجد صعوبة في المحافظة على فرادته ضمن الحشود، ليغدو ثمن الفردانية أكبر من قدرة الفرد على تحمّله، هكذا تخلق الجماعة سلوك أفرادها عبر تنميط استجاباتهم، ليغدو أي خيار خارج الصندوق مستحيلاً أو مكلفاً”
العنف الرمزي “أول الكُفر”
“دواعش”، “انفصاليون”، “همج”، “فلول”، “عملاء”، “خنازير”، “لبت لبت”، “ألطم بترتاح”، “كندرجية”… كل هذه مصطلحات رائجة يتقاذفها السوريون فيما بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يرمزون من خلالها إلى أي مخالف لهم بحسب اختلافه السياسي أو المذهبي أو العرقي أو أو الجندري أو الاقتصادي، مما يُسهِّل عملية الاستهانة به وبمعتقداته، بل وبحياته أيضاً.
تشير كنج إلى أن “العنف الرمزي مرئي جداً، فعندما أختصر جهة ما بأنهم (إرهابيون) أو (كفّار) أو (متخلّفون)، أقوم بإلغاء إنسانيتهم وأحوّل المجموعة بأكملها إلى هذه الصفة، ثم أروّج لها بالتكرار في الخطابات الإعلامية والثقافية والرقمية وغيرها، لتصبح مسلَّمات وحقيقة في خيال العوام، ثم تتحوّل إلى أداة لتبرير الانقسام واتخاذ إجراءات عنيفة بمقتضاها”.
بدوره يعتبر شبلي أننا “نخطئ لو اعتقدنا أنّ العنف يبدأ لحظة تحقّق الفعل العنيف المباشر، فمثل هذا الاعتقاد يُظهر العنف بلا جذور، وكأنّه مولود من العدم، فنشعر بالاستغراب وبصعوبة تفسير مصدر كلّ هذا الشرّ المفاجئ، الأكيد أنّ للعنف أكثر من مستوى وشكل، بل إنّ أغلبها متخفٍّ وغير مرئي، ولا يُسلّم نفسه للضوء بسهولة، ذلك أنّه يُمارَس على مستوى لا واعي وبآليات رمزية كاللغة والعادات، وضمن سياقات وبُنى اجتماعية تستبطن انحيازاتها وتطهو العنف الخام كإمكانية غريزية لدى البشر، وتمنحه ما يحتاج من أسباب ودوافع، وتوجّهه نحو آخرٍ رُسمت له ملامحه بما يتناسب مع دوره كعدو”.
ويتابع شبلي أن “خطورة هذه الجزئية أنّها لا تكشف عن نفسها، وتبدو محايدة بلا دور في خلق استجاباتنا. فنعتقد أنّنا داخلها أحرار وأصحاب رأي وقرار، فلا نستشعر دور الجامعات والجوامع ووسائل الدعاية والإعلام في تشكيل ذواتنا التي تقارب الآخر بتحيّزات وتوقّعات مسبقة عنه، سلبته أيّ ذاتية، ونزعت عنه آدميته، ليسهل علينا ممارسة الشرّ بحقّه”.
حرية الرأي والمسؤولية الاجتماعية
يخلط البعض أو الكلّ بين حريته في قول ما يريد، وبين مدى تأثير ما يقول على الآخر، خصوصاً إذا كان القول مُسبِّباً لجريمة ما، أو يُكرّس لحالة إقصائية تجاه فئة معيّنة. وهذا يجعل هناك خيطاً دقيقاً بين حرية الرأي الفردية، وما يجب أن يحمله هذا الرأي من مسؤولية اجتماعية تحفظ الاستقرار لاسيما في مجتمعات هشة ومنهكة كحالتنا في سوريا.
تُلخص كنج حديثها بهذه النقطة بأن “ حرية التعبير تنتهي عندما تصبح أداة لإيذاء الآخر، خصوصاً إذا تجاوز الموضوع النقد وتحول إلى تحريض مبني على الجندر أو الطائفة أو الأيديولوجيا. وأثبتت الدراسات أن التعرّض المستمر لخطاب الكراهية يزيد قابلية القبول به أو تبريره أو المشاركة فيه، وعليه يتحوّل الرأي إلى ضرر جماعي عندما يقع في التعميم ونزع الإنسانية. وتاريخياً، الإبادات تقوم على خطاب الكراهية والعنف الرمزي اللذين يشرعنان العنف ويخلقان أرضية لتقبّل العنف الممنهج. ففي سوريا، دوماً نربط الخطر أو الإرهاب بجماعة ما، مما يُشجّع على إقصائها ويتحوّل إلى مبرّر بحجة أنها خطر، وهو ما يشرعن خطاب الكراهية”.
وتضيف كنج أنه “يمكن إبداء الرأي ضمن مجتمع هشّ ومنهك عبر التمييز في المصطلحات المتداولة وفهمها، وذلك من خلال تأمين الحدّ الأدنى من التثقيف والتمييز بين نقد الشخص أو فعله وبناه الفكرية وهويته. فلا يمكن وسم السوريين جميعاً بأنهم متطرّفون أو وضيعون أو إقصائيون، أو القول (هاد الشعب من وين جبلكم)، بل يجب توجيه الوصف نحو السلوك، لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها نُعنف أنفسنا، فانتماؤنا الأوسع هو أننا سوريون، ومن خارج البلاد يُنظر إلينا كسوريين لا كأبناء هويات أصغر. وبالتالي، فإن قبولنا أو تبنّينا لخطاب الكراهية يُتيح لغير السوري أن يوسمنا جميعاً بصفات سلبية”.
من جانبه، يرى شبلي أن “التعامل مع حرية التعبير كغاية في ذاتها يدفعنا إلى التساؤل عن حدود هذا المكسب، ومتى يتحوّل من مكسب فردي إلى ضرر مجتمعي، وهو ما اختصرته القاعدة الشهيرة: (حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين). لكن لو أصلحنا فهمنا لحرية التعبير، ونقلناها من كونها غاية إلى كونها وسيلة لجعل وجودنا البشري أفضل، لوجدنا أنّ حرية التعبير هي أفضل وسيلة لمقاومة ما قد يجعل حياتنا أسوأ، متلطّياً خلف عبارات الصالح العام. ولتحقيق ذلك، لا بدّ من سلبنا القدرة على الرفض والتعبير، لذا لا مكان تبدأ منه لكي تنتهي عند سواه، فحرية التعبير معيار أولي، معناها قبولنا بأنّ البشر أصحاب إرادة ومسؤولية وحقوق، ويملكون أسباباً لما يريدون. ومن هنا تمثّل وسيلة لكي لا نكرّر أنفسنا إلى ما لا نهاية، فمالا يتغيّر يموت سريرياً”.
ويكمل شبلي “أمّا الحديث عن إمكانية تحوّل الرأي إلى ضرر جماعي، فهو افتراض لا معنى له، فحرية التعبير، وإن تعاطت بشخصنة مع بعض الأمور، فهذا لا ينفي أنّ رفض الناس لها بالمطلق هو من باب شخصي لا موضوعي. فالأصل في الأمور الإباحة، أمّا التقييد عليها فهو من باب إظهار مصالح ومشاعر البعض باعتبارها تمثّل الجماعة، وهي في الأصل أفكار قابلة للنقاش، سواء امتلكت سموّها من باب ديني أو عُرفي. لذا لا يمكن للرأي أن يؤدّي إلى أضرار اجتماعية، بل الأصح أن نقول إنّه قد يؤدّي إلى إلحاق الضرر بمصالح البعض ممّن جعلوا مصالحهم وأفكارهم تختصر المجتمع”.
ويؤمن شبلي وفق توصيفه بأنّ “البشر لا يعون حقيقة هشاشتهم وهشاشة بُناهم المجتمعية، وأنّهم في الغالب مضلَّلون وخاضعون لهيمنة السلطة وأكاذيبها. لذا أرى أنّ التضييق على حريات التعبير في الفضاء العام، تخوّفاً من انهياره تحت وطأة الانقسام والاختلاف، هو قيد تفرضه السلطة لتُبقينا داخل سجوننا الهوياتية. فحرية الرأي هي النور الذي يدخل كهوفنا الأفلاطونية، ليُرينا أنّ ما نراه داخلها ليس الواقع الوحيد. ومن هنا أريد أن أعكس الأمر وأقول: إنّ غياب حرية الرأي مدعاة ليبقى كلّ فرد متمترساً خلف أسوار جماعته، وهذا الأمر هو الخطر الأكبر على المجتمع، والعامل الأكثر تجذيراً للانقسام”.
كسر الحلقة
في سوريا اليوم، يدور الجميع في حلقة مُفرغة من الانقسام، حيث يصبح خطاب التفريق والكراهية هو السمة العامة على حساب خطاب الوحدة والتسامح، بطريقة يصعب معها إيجاد حلول لتجاوز هذه المرحلة. خصوصاً وأنّ كلّ فرد يعتبر الآخر هو المسؤول عمّا وصلنا إليه اليوم، لتغدو الإجابة على السؤال الذهبي: كيف نتجاوز أزمة خطابنا التقسيمي؟ حاجةً مُلحّة لضمان استمرار الجميع بسلامة على هذه الجغرافيا.
تعتقد كنج أن “الدور الأكبر في مكافحة خطابَي الكراهية والانقسام يقع على القانون والحكومة والإعلام، فهم قادرون على ضبط الانفعالات، وتوعية الناس، وكسر حلقة تداول هذين الخطابين، خصوصاً من خلال القوانين ومدوّنات السلوك والعقد الاجتماعي، وحماية الذاكرة، وتعزيز التسامح، أما فردياً، تنكسر الحلقة من خلال تفعيل الضمير، وتربية الأطفال على مدّ الجسور مع الآخرين لا رفضهم، والمشاركة الفعّالة في رفض الخطاب السلبي بعيداً عن الصمت. فنحن لسنا ضحايا خطاب الكراهية والمؤامرة والاحتلال فقط، بل نحن أيضاً منتجون لهذا الخطاب”.
“يبدأ كلّ شيء بالاعتراف بإنسانية الآخر دون قيد”، هكذا يرى شبلي الحل لكسر حلقة خطاب العنف ويتابع “هذا الاعتراف يبدأ من التسليم بحقه في الاختلاف وبقوله ما يريد، إذ إنّ كلّ عدو هو آخر لم نستمع لقصته أو حاولنا طمسها. ومن هنا يستحقّ كلّ آخر احتراماً غير مشروط لكونه إنساناً بالمبدأ، ثمّ علينا أن نعي أنّ الحقيقة متعدّدة بعدد البشر، وأنّ رفضنا للكراهية لا يعني الانشغال بهموم الآخرين على حساب مصالحنا، بل يعني ألّا ننشغل بأذيتهم والتسبّب بشقائهم”.
يتسع الفضاء، وخصوصاً الرقمي منه، لكل الأصوات، لكن علينا أن ندرك أننا لسنا مجرد متفرجين، بل صانعي ملامح الخطاب العام. كل كلمة نكتبها، وكل إشارة نتركها، قد تكون شرارة انقسام أو رصاصة في قلب الآخر. وحين ندرك أن التفاصيل الصغيرة تترك أثرًا كبيرًا، يصبح الوعي الفردي فعلًا يوميًا لا يقل أهمية عن القضايا الاستراتيجية الكبرى. بمعنى أنّه بأيدينا أن نختار بين صناعة الكراهية وترسيخ الانقسام، أو بين خطاب وحدوي متسامح يحترم الآخر ويحميه، وذلك من خلال وعينا وإيماننا بوطننا الواحد قبل أي قانون أو قرار أو إعلام.
تلفزيون الخبر